أبو حنيفة النعمان: الإمام الأعظم
يُعدُّ الإمامُ أبو حنيفةَ النعمانُ بنُ ثابتٍ الكوفيُّ واحداً من أبرزِ فقهاءِ الإسلامِ عبرَ العصور، وأولَ الأئمةِ الأربعةِ الذينَ نُسبت إليهم المذاهبُ السنيةُ المعروفة. وُلدَ سنةَ ثمانينَ للهجرةِ في مدينةِ الكوفةِ، تلكَ الحاضرةِ التي امتزجَ فيها العلمُ العربيُّ بالتقاليدِ الفارسيةِ، وتُوفِّي في بغدادَ سنةَ مئةٍ وخمسينَ للهجرةِ. لُقِّبَ بالإمامِ الأعظمِ لأنَّه كانَ سبَّاقاً إلى تقعيدِ علمِ الفقهِ، وجمعِ مسائلهِ، وبناءِ مناهجَ استدلاليةٍ قائمةٍ على الجمعِ بينَ النصِّ والعقل. تركَ أثراً عميقاً في التاريخِ التشريعيِّ الإسلاميِّ، وما زالَ مذهبُهُ الحنفيُّ حياً في قلوبِ المتعلمينَ وساحاتِ القضاءِ في حقبٍ كثيرةٍ بعدَه. لقد لاقتْ شخصيةُ هذا الإمامِ اهتماماً بالغاً من المستشرقينَ والمؤرخينَ المعاصرينَ، لأنَّ تجربتَهُ تكشفُ كيفَ يمكنُ لعقلٍ فرديٍّ أنْ يؤسسَ نظريةً فقهيةً تتبناها إمبراطورياتٌ لاحقةٌ، وتتجاوزُ حدودَ اللغةِ والثقافةِ. كما تُبيِّنُ لنا سيرتُهُ كيفَ أنَّ سوقَ الكوفةِ الصاخبَ بالبيوعِ والعقودِ أنجبَ فقيهاً قادراً على تفكيكِ المعاملاتِ اليوميةِ وإعادةِ صياغتِها في قوالبَ شرعيةٍ رشيدةٍ.
نشأته وطلبه للعلم
نشأَ أبو حنيفةَ في بيتٍ متديِّنٍ يمتهنُ التجارةَ في الأقمشةِ الفاخرةِ، فشبَّ على حبِّ العملِ والكسبِ الحلالِ، جنباً إلى جنبٍ معَ حبِّ المعرفةِ. كانَ أبوهُ ثابتٌ من التابعينَ الذينَ أدركوا عدداً من الصحابةِ، وربَّاهُ على أخلاقياتِ الصدقِ والأمانةِ. عملَ الشابُّ النعمانُ في متجرِ العائلةِ، غيرَ أنَّ مجالسَ العلماءِ في الكوفةِ استمالتْ قلبَهُ سريعاً، ولا سيما مجلسَ حمادِ بنِ أبي سليمان، الفقيهِ الكوفيِّ الكبيرِ. لبثَ عندَ شيخِهِ ثماني عشرةَ سنةً لا يكادُ يفارقهُ، حتى شهدَ له أقرانُهُ بأنَّهُ أضحى أعلمَ أهلِ العراقِ في زمانِه. ثمَّ رحلَ إلى الحجازِ والبصرةِ والشامِ؛ يلتقي التابعينَ مثلَ عطاءٍ ونافعٍ، ويأخذُ الحديثَ عن أنسِ بنِ مالكٍ وآخرينَ ليدعمَ إلمامَهُ بالنصوصِ المرويةِ. بهذا المزيجِ من التكوينِ المحليِّ والسفرِ بغرضِ التوثيقِ توسَّعت مداركُهُ، وصارَ صِلَةً علميةً بينَ جيلِ الصحابةِ والفقهاءِ. ورغمَ انشغالهِ بالتجارةِ كانَ يبادرُ إلى الرحلةِ في طلبِ العلمِ؛ فسافرَ إلى مكةَ مراراً حيثُ التقى عطاءَ بنَ أبي رباحٍ، وجاورَ في الحرمِ شهوراً يستمعُ إلى العلماءِ ويقابلُ المسائلَ بقلبٍ يقظٍ. ثمَّ شدَّ الرحالَ إلى البصرةِ ليساجلَ الخوارجَ في مسائلِ العقيدةِ، ويعودَ بمخزونٍ جدليٍّ صقلَ موهبتهُ في المناظرةِ.
منهجه في الفقه
اعتمدَ الإمامُ أبو حنيفةَ في استنباطِ الأحكامِ على منهجيةٍ مرتَّبةٍ بدقةٍ تُقدِّمُ القرآنَ، ثمَّ السنةَ الصحيحةَ، فالإجماعَ، فالقياسَ الجليَّ، فالاستحسانَ حيثُ تدلُّ القرائنُ على مصلحةٍ معتبرةٍ لا تصطدمُ بنصٍّ، ثمَّ العرفَ والعادةَ كضابطَيْنِ لطبيعةِ التعاملاتِ البشريةِ، وأخيراً اعتبارِ سدِّ الذرائعِ منعاً لانزلاقِ الناسِ إلى الحرامِ تحتَ غطاءٍ من الحيلِ. كانَ شديدَ الاحتياطِ في قبولِ الحديثِ، فلا يكتفي بصحةِ السندِ، بل يشترطُ سلامةَ الراوي من التهمةِ، وخلوَّ متنِ الحديثِ من معارضةِ القرآنِ أو السنةِ الأثبتِ. قلَّت الرواياتُ التي أسندها مقارنةً بمالكٍ أو أحمدَ، إلا أنَّه عوَّضَ ذلكَ بعقليةٍ جدليةٍ تُحسنُ تمحيصَ العللِ وبناءَ الفروضِ الافتراضيةِ لمعالجةِ القضايا المَعنيَّةِ بمستقبلِ الأمةِ. اشتهرَ مجلسُهُ بكونهِ حلقةً تُطرحُ فيها المسائلُ المفترضةُ لتحفيزِ الذهن، وهو أسلوبٌ تعليميٌّ رائدٌ يشبهُ المختبرَ القانونيَّ في عصرنا المعاصرِ. وابتكرَ أبو حنيفةَ مبدأَ «فقهِ الواقعِ» إذْ كانَ ينظرُ إلى عوائدِ الناسِ وأسواقِهم قبلَ الفتوى، فلا يكتفي بالنصوصِ المجردةِ. وهذا ما جعلَهُ يقدِّمُ حلولاً لمسائلِ قروضِ التجارِ، وضماناتِ النقودِ، وصكوكِ المضاربةِ، في زمنٍ شهدَ توسعاً تجارياً غيرَ مسبوقٍ .
اجتهاداته وأمثلة من فقهه
أثمرَ منهجُهُ عدداً من الاجتهاداتِ التي ميَّزتهُ، منها أنَّ لمسَ المرأةِ لا ينقضُ الوضوءَ لأنَّ النصَّ لم يصرِّحْ به ناقضاً، وأنَّ شرابَ النبيذِ غيرِ المسكرِ مباحٌ إذا خلا من الإسكارِ، مستنداً إلى حفظِ المصالحِ ودرءِ المفاسدِ. وفي بابِ المعاملاتِ أجازَ بيعَ الوفاءِ، حيثُ يشترطُ المشتري على البائعِ إعادةَ السلعةِ بعدَ استيفاءِ المنفعةِ، تيسيراً على أصحابِ الحاجاتِ، كما أجازَ بيعَ المرابحةِ اعتماداً على الشفافيةِ في كشفِ رأسِ المالِ والربحِ. أما الحدودُ فكانَ يتحرى فيها أقصى درجاتِ الاحتياطِ، فيسقطُ الحدَّ عندَ أدنى شبهةٍ، مقتدياً بحديثِ «ادرؤوا الحدودَ بالشبهاتِ». وكانَ لا يترددُ في تعديلِ موقفِه إذا ظهرَ له دليلٌ أقوى، سمةً جعلتْ فقهَهُ حيّاً قابلاً للتطويرِ وفقاً لمعطياتِ الواقع.
صفاته الشخصية وأخلاقه
جمعَ أبو حنيفةَ بينَ حدةِ الذكاءِ وسدادِ الرأيِ وحُسنِ الخُلُقِ. عُرفَ بكرمِه؛ إذْ كانَ يربِّحُ شريكَهُ في التجارةِ، ويُنفِقُ على طلابهِ، ويكسو الفقراءَ بثيابٍ فاخرةٍ. وكانَ صبوراً حليماً؛ يقابلُ جفاءَ سائليهِ بابتسامةٍ، ويشرحُ أدلتَهُ برويَّةٍ. اشتهرَ بورعهِ في الكسبِ؛ فلا يقبلُ عطيةَ السلطانِ حتى لا يُتَّهمَ بالميلِ. وكانَ قيامُهُ بالليلِ منتظماً حتى قيلَ إِنَّهُ صلَّى الفجرَ بوضوءِ العشاءِ أربعينَ عاماً، وهو تعبيرٌ عن ملازمتِه للعبادةِ لا حصرٌ حسابيٌّ بالضرورةِ .
محنته مع العباسيين
بلغَتْ شجاعتُهُ حدَّ رفضِ تولي القضاءِ حينَ عرضهُ عليهِ الخليفةُ العباسيُّ أبو جعفرٍ المنصورُ، لأنَّه أدركَ أنَّ القضاءَ تحتَ سلطةٍ تنفيذيةٍ متغوِّلةٍ قد يقودُ إلى تسييسِ الأحكامِ. أصرَّ الخليفةُ، فحلفَ الإمامُ أنَّهُ غيرُ أهلٍ للمنصبِ، معتبرًا يمينهُ يمينَ عدمِ قدرةٍ لا يمينَ كذبٍ. وأرادَ المنصورُ إلزامَهُ، فجلدهُ وسجنهُ. وبرغمِ التعذيبِ رفضَ القبولَ، متحملًا الأذى ثباتاً على استقلالِ القضاءِ. يُروى أنَّهُ تُوفِّي في محبسهِ مسموماً أو متأثراً بالتعذيبِ سنةَ مئةٍ وخمسينَ للهجرةِ، فاجتمعَ على جنازتِه آلافٌ، وصلَّوا عليهِ ستَّ مراتٍ من شدَّةِ الزحامِ، في مشهدٍ يعكسُ مكانتَهُ في قلوبِ الناسِ .
أقوال العلماء فيه
تتابعَ الثناءُ عليهِ من كبارِ الأئمةِ؛ فقالَ الشافعيُّ: «الناسُ عيالٌ في الفقهِ على أبي حنيفةَ»، إقراراً بأنَّ منهجَهُ سبقَ زمانَهُ. وقالَ مالكٌ: «لو شاءَ أن يجعلَ هذا العمودَ ذهباً لقدرَ بحجتِه»، إشارةً لقوةِ استدلالهِ وإقناعِه. وذكرَ الذهبيُّ في «سيرِ أعلامِ النبلاءِ» أنَّهُ كانَ عالِماً ثقةً، من أوعيةِ العلمِ. ورأى ابنُ تيميةَ أنَّهُ من أذكى الناسِ وأشدِّهم ورعاً. مولِّداً من هذا الثناءِ سلسلةَ اعترافاتٍ متبادلةٍ بينَ المذاهبِ بأحقيتِه في الريادةِ .
انتشار مذهبه وتأثيره
حينَ تحوَّلت الدولةُ العباسيةُ إلى تبنِّي فقهِه في دواوينِها، انتشرَ المذهبُ الحنفيُّ من العراقِ إلى خراسانَ وما وراءَ النهرِ، ثمَّ تبنَّتهُ الدولةُ العثمانيةُ مذهباً رسمياً في قراراتِ القضاءِ والإدارةِ، فتضاعفَ حضورُهُ في الأناضولِ والبلقانِ ومصرَ والشامِ والهندِ وآسيا الوسطى. اعتمدَ تلامذتُهُ، وعلى رأسِهم أبو يوسفَ ومحمدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ، على تدوينِ المسائلِ وتطبيقها على الوقائعِ الناشئةِ في الأسواقِ والمرافعاتِ، فصارَ الفقهُ الحنفيُّ أكثرَ مواءمةً للتعقيدِ التجاريِّ والحضريِّ. وحينَ وصلتْ الفتوحاتُ العثمانيةُ إلى أوروبا حَمَلَ القضاةُ الحنفيةُ معهم أصولاً إجرائيةً أثَّرتْ في تقنينِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ في البوسنةِ وألبانيا لاحقاً. وقد احتضنَ القضاءُ العثمانيُّ كتبَ أبي يوسفَ وكتبَ محمدِ بنِ الحسنِ بوصفها مرجعاً رسمياً، وظلَّ كتابُ «المُختارِ» معياراً لدراسةِ القضاةِ حتى القرنِ التاسعَ عشرَ. وبفضلِ المدارسِ النظاميةِ في نيسابورَ وبغدادَ وسمرقندَ انتشرتْ الشروحُ الحنفيةُ، وأنتجتْ حاشياتٍ وتعليقاتٍ لا حصرَ لها، حافظتْ على حيويةِ المذهبِ وهمّتِه .
أثره العلمي على الأمة
أثَّرَ الإمامُ أبو حنيفةَ كذلكَ في بناءِ علمِ أصولِ الفقهِ؛ إذْ أسسَ فكرةَ ترتيبِ الأدلةِ، وفصلِ ما يُقبلُ من القياسِ وما يُردُّ، ووضعَ اصطلاحاتٍ مثلَ «الاستحسانِ» لتعطي مرونةً حينَ يتعارضُ القياسُ الظاهرُ مع مصلحةٍ راجحةٍ. واعتمدَ عليهِ علماءُ الكلامِ في ضبطِ منهجِ الجدلِ؛ لأنهُ كانَ أوَّلَ من حوَّلَ حلقةَ الدرسِ إلى مناظرةٍ مفتوحةٍ يقدِّمُ فيها الطلابُ اعتراضاتِهم واحدةً تلو الأخرى، فيتولَّى الردَّ بحججٍ مرتبةٍ. وبهذا النهجِ تأسسَ ما سمَّاهُ المؤرخونَ «مدرسةَ الرأيِ» القائمةِ على التحليلِ المنطقيِّ المنضبطِ، ما أوجدَ توازناً مع «مدرسةِ الحديثِ» في الحجازِ. ولا يقتصرُ التأثيرُ على الفقهِ؛ ففي مجالِ الاقتصادِ الإسلاميِّ الحديثِ يستندُ الباحثونَ إلى مفاهيمِ الاستحسانِ والمرابحةِ والتورقِ التي أصلَها الحنفيةُ في تحديدِ بدائلَ معاصرةٍ للتمويلِ. كما تُستخدمُ نظريةُ أبي حنيفةَ في «ولايةِ القاضي على مالِ الغائبِ» لإرساءِ تشريعاتِ الوقفِ والأسرةِ في كثيرٍ من الدولِ الإسلاميةِ اليومَ .
ختاما
إنَّ سيرةَ الإمامِ أبي حنيفةَ تجمعُ بينَ العلمِ والورعِ والشجاعةِ في آنٍ واحدٍ؛ فهو الذي ذادَ عن حريةِ الاجتهادِ أمامَ السلطةِ، وقدمَ نموذجاً للمفكرِ المستقلِّ الذي يزاوجُ بينَ احترامِ النصِّ واستيعابِ الواقعِ. ظلَّ مذهبُهُ عنواناً للسعةِ والمرونةِ، وقدَّمَ للأمةِ أدواتٍ مِلَّيةً لمواكبةِ التحولاتِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ عبرَ قرونٍ. ولئنْ تعددتِ المدارسُ الفقهيةُ يبقى مذهبُ الإمامِ الأعظمِ أحدَ أعمدةِ الفقهِ، يُلهمُ الباحثينَ إلى يومِ الناسِ هذا. وما زالتْ الجامعاتُ والمعاهدُ الإسلاميةُ تُدرِّسُ «الفقهِ الحنفيَّ المقارنَ» لتُظهرَ للطالبِ كيفَ يمكنُ جمعُ الأدلةِ وترتيبُها دونَ تفريطٍ أو غلوٍّ، وكيفَ تُرعى مقاصدُ الشريعةِ في تفاصيلِ حياةِ الناسِ اليوميةِ. وإدراكاً لأهميةِ هذا التراثِ صدرَتْ طبعاتٌ نقديةٌ جديدةٌ لكتبِ الإمامِ وتلامذتِه معَ تحقيقاتٍ علميةٍ تسهِّلُ للباحثينَ الرجوعَ إلى الأصولِ. إنَّ استمرارَ هذا العطاءِ شاهدٌ حيٌّ على أنَّ العلمَ الصادقَ لا يبلى، بل يزدادُ رسوخاً عبرَ الأجيالِ. وسيبقى اسمه محفوراً في ذاكرة الأمة مرجعاً ثابتاً لكل باحث جاد يسعى إلى فهم مقاصد الشرع وأبعاد الاجتهاد الرشيد على مرور العصور المتعاقبة .
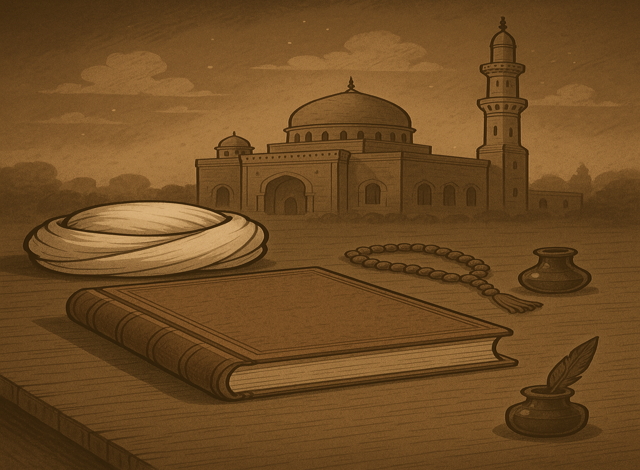
إرسال التعليق